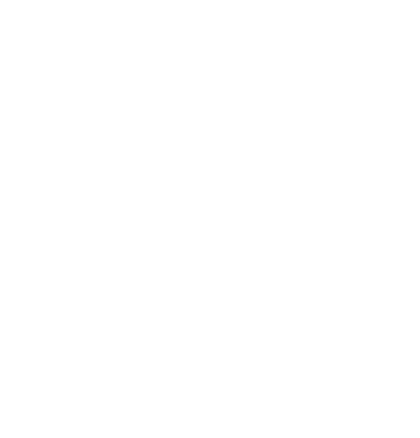شهد التاريخ عدة غزوات وحروب، كانت نتائجها حاسمة في تغيير مجراه، وسنتناول على صفحات الجندي بعضاً من هذه المعارك الفاصلة.
غزوة مؤتة
وقعت في بلدة مؤتة بمحافظة الكرك في الأردن في العام الثامن للهجرة بين جيش المسلمين من جهة والروم والغساسنة من جهة أخرى.
تعتبر غزوة مؤتة أول غزوة يخوضها المسلمون خارج حدود الجزيرة العربية، صمد فيها ثلاثة آلاف مقاتل مسلم أمام مائتي ألف من الروم والقبائل العربية الحليفة لهم لمدة ستة أيام كاملة، انتهت المعركة في اليوم السابع بعد قيام قائد الجيش خالد بن الوليد بانسحاب تكتيكي ناجح وبأقل الخسائر.
وقد استشهد في هذه الغزوة القادة المسلمون الثلاثة الذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم لقيادة المعركة، وهم على الترتيب: زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبدالله بن رواحة.
خلفية الأحداث
بعد هزيمة قريش وحلفائها في غزوة الأحزاب، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع قريش، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى الملوك والرؤساء في البلاد المجاورة يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكان من ضمن الذين أرسل إليهم رسالة، ملك بُصرى، وحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الحارث بن عمير الأزدي، فاعترضه شرحبيل بن عمرو الغساني والي البلقاء الواقع تحت الحماية الرومانية وأوثقه وضرب عنقه.
كان من المتعارف عليه بين الملوك وزعماء القبائل أن الرسل لا يُقتلون ولا يجوز لأحد أن يتعرض لهم، لأنهم يحملون مجرد رسائل من أقوامهم، وقد مثَّل قتل الحارث بن عمرو الأزدي، انتهاكاً كبيراً لهذا العُرف، وكان هذا بمثابة إعلان الحرب على المسلمين. اشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم حين نقلت إليه الأخبار، فجهز جيشاً قوامه ثلاثة آلاف مقاتل، وهو أكبر جيش إسلامي لم يجتمع مثله قبل ذلك إلا في غزوة الخندق.
الاستعداد للمعركة
أمَّر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش زيد بن حارثة، وقال: (إن قُتل زيد فجعفر، وإن قُتل جعفر فعبدالله بن رواحة)، وعقد لهم لواءً أبيضَ، ودفعه إلى زيد بن حارثة. وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير، وأن يدعوا مَنْ هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم، وقاتلوهم، وقال لهم: (اغزوا بسم الله، في سبيل الله، مَنْ كفر بالله، لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة، ولا كبيراً فانياً، ولا منعزلاً بصومعة، ولا تقطعوا نخلاً ولا شجرة، ولا تهدموا بناء). وقد خرجت نساء المسلمين لتوديع أزواجهن وهن يقلن ((ردكم الله إلينا صابرين)) فرد عبدالله بن رواحه وقال ((أما أنا فلا ردني الله)).
عند مدينة مؤتة توقف المسلمون، وكان عددهم ثلاثة آلاف، وعدد الغساسنة والروم مئتا ألف. اختار المسلمون بقيادة زيد بن حارثة، الهجوم على البيزنطيين وتم الهجوم بعد صلاة الفجر وكان اليوم الأول هجوماً قوياً، في صالح المسلمين لأن الروم والغساسنة لم يتوقعوا من جيش صغير البدء بالهجوم. وفي اليوم الثاني، بادر المسلمون أيضاً بالهجوم وكان في صالح المسلمين، وقُتل كثير من الروم وحلفائهم. أما في اليوم الثالث فقد بادر الروم بالهجوم وكان أصعب وأقوى الأيام وفيه قتل زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة، واختار المسلمون خالد بن الوليد قائداً لهم.
المجلس الاستشاري بمعان
لم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم، الذي بوغتوا به في هذه الأرض البعيدة، وهل يهجم جيش صغير قوامه ثلاثة آلاف مقاتل فحسب على جيش كبير قوامه مائتا ألف مقاتل؟ حار المسلمون، وأقاموا في مَعَان ليلتين يفكرون في أمرهم، وينظرون ويتشاورون، ثم قالوا: نكتب إلى رسول الله، فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال، وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. ولكن عبدالله بن رواحة عارض هذا الرأي، وشجع الناس، قائلاً: (يا قوم والله إن التي تكرهون لَلَّتِي خرجتم تطلبون، الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة.)، وأخيراً استقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله بن رواحة.
بدء القتال وتناوب القادة
وهناك في مؤتة التقى الفريقان، وبدأ القتال المرير، ثلاثة آلاف رجل يواجهون مائتي ألف مقاتل. أخذ الراية زيد بن حارثة وجعل يقاتل بضراوة بالغة، فلم يزل يقاتل حتى شاط في رماح القوم، وخر شهيداً. وحينئذٍ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، وطفق يقاتل قتالاً منقطع النظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها، ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله، ولم يزل بها حتى قطعت شماله، فاحتضنها بعضديه، فلم يزل رافعاً إياها حتى استشهد، ولما استشهد جعفر بعد أن قاتل بمثل هذه الضراوة والبسالة، أخذ الراية عبدالله بن رواحة، فتقدم، فقاتل حتى استشهد.
الراية إلى خالد بن الوليد
تقدم رجل من بني عَجْلان، اسمه ثابت بن أقرم، فأخذ الراية وقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم، قالوا: أنت، قال: ما أنا بفاعل، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية قاتل قتالاً مريراً، فقد روى البخاري عن خالد بن الوليد قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة، مخبراً بالوحي، قبل أن يأتي إلى الناس الخبر من ساحة القتال: (أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب ـ وعيناه تذرفان ـ حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، حتى فتح الله عليهم).
نهاية المعركة
من المستغرب أن ينجح هذا الجيش الإسلامي بعدده القليل في الصمود أمام ذلك الجيش الكبير من الروم، ففي ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليد مهارته في تخليص المسلمين مما لقوه في تلك المعركة. واختلفت الروايات كثيراً فيما آل إليه أمر هذه المعركة أخيراً. ويظهر بُعْد النظر في جميع الروايات أن خالد بن الوليد نجح في الصمود أمام جيش الرومان طول النهار، في أول يوم من القتال. وكان يفكر بمكيدة حربية تُلقي الرعب في قلوب الرومان بحيث ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة. فقد كـان يعرف جيداً أن الإفلات منهم صعب جداً لو انكشف المسلمون، وقام الرومان بالمطاردة.
فلما أصبح اليوم الثاني اعتمد خالد بن الوليد في خطته على الحرب النفسية، حيث أمر عدداً من الفرسان بإثارة الغبار خلف الجيش، وأن تعلو أصواتهم بالتكبير والتهليل، وقام كذلك بتبديل الرايات وغير أوضاع الجيش، وعبأه من جديد، فجعل مقدمته ساقة، وميمنته ميسرة، وهكذا دواليك، فلما رآهم الروم أنكروا حالهم، وقالوا: جاءهم مدد، فرعبوا، وسار خالد بعد أن تراءى الجيشان وهجم على الروم وقاتلهم، ثم أمر خالد بانسحاب الجيش بطريقة منظمة، وأخذ يتأخر بالمسلمين قليلاً قليلاً، مع حفظ نظام جيشه، ولم يتبعهم الرومان ظناً منهم أن المسلمين يخدعونهم، ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء ولم يتبعوا خالداً في انسحابه. فانحاز الرومان إلى بلادهم، ولم يفكروا في القيام بمطاردة المسلمين ونجح المسلمون في الانحياز سالمين، حتى عادوا إلى المدينة.
عودة الجيش إلى المدينة
لما عاد جيش مؤتة إلى المدينة تلقاهم الرسول والمسلمون، فجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون يا فرار فررتم في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله.
أثر المعركة
وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر، لكنها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين، إذ أدهشت العرب كلها بقبائلها، فقد كانت الدولة البيزنطية أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض، وكانت العرب تظن أن قتالها هو القضاء على النفس، فكان لقاء هذا الجيش الصغير (ثلاثة آلاف مقاتل) مع ذلك الجيش الكبير (مائتا ألف مقاتل) ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خسارة كبيرة، يعد عظيماً مما رفع من شأن الدولة الإسلامية الناشئة.
إعداد: نادر نايف محمد