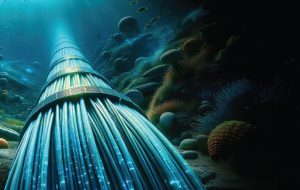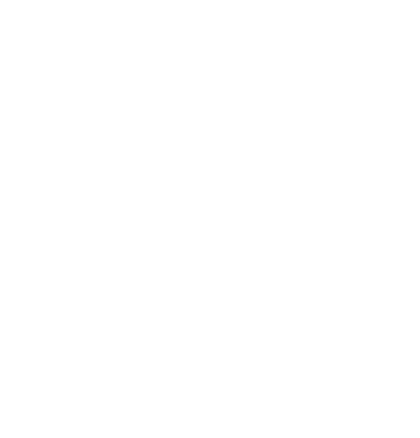على الرغم من صعوبة تقدير إجمالي انبعاثات الكربون الصادرة عن جيوش العالم والصناعات العسكرية المرتبطة بها، فإن هناك بعض التقارير الغربية التي قدرت إجمالي البصمة الكربونية للقوات المسلحة العالمية بنحو 5% من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون، كما أعلن “المجلس العسكري الدولي المعني بالمناخ والأمن” في عام 2021، أن الدفاع يعد أكبر مستهلك مؤسسي للهيدروكرونات في العالم.
وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 2015، تم الاتفاق على الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة، وهو ما يتطلب تقليل مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية لصفر انبعاثات كربونية بحلول منتصف القرن الحالي، ما يعني تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العسكري، وقد أضحى هناك قناعة لدى الغرب بأن الجيوش عليها دور رئيسي في تقليل مستويات الانبعاثات الكربونية.
وبالتالي، في إطار التحولات العالمية الراهنة بمجال الطاقة، استجابةً لأزمات المناخ المتفاقمة، ومحاولة الوصول لصافي الانبعاثات الصفرية، أصبح هناك العديد من التحديات التي تواجه العمليات العسكرية المستقبلية. وفي هذا السياق، طَرَحت العديد من الأدبيات فكرة «الحرب منخفضة الكربون» باعتبارها مقاربة يمكن أن تساعد على فك الاشتباك فيما يتعلق بأنشطة الجيوش خلال العقود القادمة، بالتزامن مع التوجهات الراهنة للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.
تأثير تغير المناخ على بيئات العمليات العسكرية
في عام 2019، رجَّح رئيس الأركان العامة آنذاك في المملكة المتحدة، الجنرال السير «مارك كارلتون سميث»، أن يكون الجيل الحالي من المعدات العسكرية هو الأخير الذي يعتمد على محركات الوقود الأحفوري. ويشير مفهوم «الحرب منخفضة الكربون» (يطلق عليها أيضاً الحرب محايدة الكربون) إلى التغيرات المحتملة في كيفية عمل الجيوش، في إطار التوجهات الراهنة لحساب تكاليف الكربون ضمن عملية صنع القرار العسكري.
وعلى الرغم من تنامي الاهتمام الدولي بشكل مطرد بدايةً من سبعينات القرن الماضي، بيد أن التركيز على العلاقة بين المناخ والأمن لم يكتسب أهمية حقيقية سوى في منتصف الثمانينات من القرن ذاته، وبالتحديد في عام 1987 عندما أطلقت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية تقرير «مستقبلنا المشترك»، والذي ألمح إلى ضرورة الاهتمام بالعلاقة بين الأمن والمناخ، ومن ثم ظهور مفهوم «الأمن البيئي»، حيث شرعت العديد من الدول إلى دمج المناخ ضمن استراتيجيات الأمن القومي. فعلى سبيل المثال، انطوت استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الصادرة في أكتوبر 2022 على إشارة إلى أن تغير المناخ بات يشكل تحدياً وجودياً في الوقت الراهن. والأمر ذاته عكسته استراتيجيتا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وكذا استراتيجية الأمن القومي الروسية لعام 2021، والتي نصت صراحةً على التهديد الأمني للتغيرات المناخية والحاجة إلى الوقاية والتكيف معه.
وثمة تداعيات واسعة للتغيرات المناخية والظواهر الجوية المتطرفة على بيئة عمل الجيوش وبنيتها التحتية والقدرات والمعدات العسكرية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي التغيرات المناخية إلى إغراق القواعد العسكرية الساحلية، وهو ما ينعكس بوضوح في حالة الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتعرض قاعدتها العسكرية البحرية «نورفولك» لفيضانات متكررة. وتواجه الصين الخطر ذاته على قواعدها العسكرية الساحلية في «هاينان» و«جيانغسو».
بالإضافة لذلك، سيؤدي تغير المناخ إلى دفع القوات المسلحة للعمل في بيئات متغيرة، والاضطرار إلى التعامل مع الصراعات المتزايدة على السلطة والموارد، فضلاً عن الانخراط في مهام جديدة وشروط جديدة للتدخل. ومن الأمثلة الواضحة على تأثير التغيرات المناخية على بيئات العمليات العسكرية ما يتعلق بتأثير هذه التغيرات على ملوحة مياه البحر وما يتبعه من تأثيرات كبيرة على بيئات عمل الغواصات والعمليات المضادة للغواصات. يضاف لذلك تأثيرات التغيرات المناخية على محطات الطاقة النووية، والتي تم بناؤها في وقت لم يكن هناك أخذ للأبعاد المناخية في الاعتبار، ومن ثم تزايد خطر الأضرار المحتملة من هذه المحطات لا سيما في ظل عدم إجراء أي تعديلات على المحطات النووية.
أيضاً، سيكون للتغيرات المناخية تأثيرات مباشرة على بيئات عمل القوات المسلحة من خلال إعادة نشر هذه القوات على نطاق متزايد في مناطق ذات ظروف مناخية قاسية، سواء في درجات حرارة منخفضة للغاية، كالقطب الشمالي الذي بات يشكل بؤرة تنافس جيواستراتيجية بسبب ذوبان الجليد المستمر، أو مناطق ذات درجات حرارة مرتفعة كالشرق الأوسط وإفريقيا. وفي هذا الإطار، أشارت بعض التقديرات إلى عدم قدرة الولايات المتحدة على استخدام مقاتلتها الشبحية «F35» في درجات الحرارة المرتفعة.
كما أن الظروف المناخية القاسية لا تؤثر فقط على المعدات والمهام العسكرية وتجبر الجيوش على تقليل عدد هذه المهام وأوزان الحمولات الموجودة على الطائرات الحربية، ناهيك عن تأثيرها على أنظمة الرصد والتحكم، لكنها تؤثر أيضاً على الحالة الصحية للجنود وقدرتهم على التحمل، فقد بلغ عدد الجنود البريطانيين الذين تأثروا بدرجات الحرارة العالية في العراق عام 2003 حوالي 800 حالة.

التحول من «تخضير الدفاع» إلى خفض الكربون في العمليات العسكرية
منذ عدة عقود ماضية، ترسخت قناعة لدى الدول المختلفة مفادها أن التغيرات المناخية لها تداعيات سلبية على الأمن الوطني والدولي، وقد عبرت القوى الغربية عن تخوفاتها من هذه الانعكاسات من خلال إطلاقها لمفهوم «الأمن المناخي»، والذي يعبر بالأساس عن الارتدادات المحتملة للتغيرات المناخية على تفاقم حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن وتأجيج الصراعات العنيفة حول العالم.
ورغم ميل الجيوش الوطنية للدول المختلفة إلى الإعفاء من التشريعيات البيئية، فإنها خلال السنوات الأخيرة من الحرب الباردة برزت الدعوات الأولى لـ«تخضير الجيوش»، وقد تم تأكيد هذا الأمر خلال بروتوكول كيوتو عام 1997، والذي أثار قضية الانبعاثات العسكرية. ومنذ مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تزايدت الضغوط الداخلية على وزارات الدفاع الغربية لخفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما دفع بعض هذه الدول، أبرزها المملكة المتحدة، إلى إصدار تشريعات وطنية تحدد أهدافاً واضحة وملزمة تتعلق بالانبعاثات الكربونية، في مؤشر واضح على اتجاه الدول الغربية لمحاولة خفض البصمة الكربونية للدفاع، بيد أن المعيار الرئيسي في هذه التوجهات تمثل بالأساس في ضمان عدم تأثير «تخضير الجيوش» على فاعلية العمليات العسكرية للقوات العسكرية الوطنية.
ويقصد بـ «تخضير الجيوش»، والتي يطلق عليها أيضاً «الجيوش صديقة البيئة»، «توجه الجيوش نحو استخدام مصادر الطاقة الصديقة للبيئة والمتجددة، وذلك من خلال السعي لإحداث تغييرات استراتيجية في بنية الجيوش والتوجه لبناء منظومات تقلل من الاعتماد على الأسلحة التي تزيد من الانبعاثات الكربونية، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة لتأمين احتياجات الجيوش من الطاقة».
أسباب اهتمام الحكومات الغربية بتخضير الجيوش
تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المحددات الرئيسية التي دفعت الحكومات الغربية في هذه الفترة للاهتمام بتخضير الجيوش، ارتبطت بالارتفاع المتنامي في أسعار النفط آنذاك، فضلاً عن التداعيات المرتبطة بحربي أفغانستان والعراق، ما يعني أن الاهتمام في هذه الحقبة ارتكز على التخوفات المتعلقة بتزايد تكلفة الأنشطة العسكرية المعتمدة على الوقود الأحفوري. ولعل هذا ما يفسر تراجع الاهتمام الغربي بتخضير الجيوش بعد الانسحاب من العراق، وبشكل أكبر بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمي عام 2014 وضم روسيا لشبه جزيرة القرم، حيث عمد حلف الناتو إلى تعزيز قدراته الدفاعية التقليدية في القارة الأوروبية، وهو ما اعتبرته بعض التقديرات بمثابة نهاية للموجة الأولى للاهتمام الغربي بتخفيض الكربون في العمليات العسكرية تحت مظلة مفهوم «تخضير الدفاع».
وكان أحد أبرز مخرجات الموجة الأولى هو أنه بالإمكان إقناع الجيوش بتخفيض الانبعاثات الكربونية طالما أن هذا الأمر لا يؤثر في فاعلية القدرات العسكرية. ومن هذا المنطلق، جاءت اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 لتؤطر إلى موجة جديدة من الاهتمام الدولي بخفض الانبعاثات الكربونية بشكل عام لتحقيق هدف الوصول إلى درجات حرارة بحد أقصى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل التصنيع، والوصول إلى صافي انبعاثات كربونية بحلول سنة 2050، وبموجبها تعهدت الدول المختلفة الموقعة على الاتفاقية بتخفيف انبعاثاتها الوطنية، ولم يتم استبعاد الجيوش من هذا التخفيض. لكن، لا يزال التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، ويعد مهمة معقدة، حيث لا تزال المسؤولية الرئيسية للجيوش هي حماية الدول، وبالتالي فمتطلبات الحفاظ على القدرة للقيام بهذه المهمة ستؤثر على الأرجح في سرعة ونطاق أي تحول إلى بدائل للوقود الأحفوري. وقد عكست الحرب الأوكرانية مؤشراً مهماً بأنه عندما يتعلق الأمر بالبقاء الوطني للدول، فإنها ستكون على استعداد لتجاوز قضية الانبعاثات الكربونية والمناخ.
وعلى الرغم من ذلك، عمدت بعض مراكز الأبحاث الدفاعية والأمنية، لا سيما «مركز التميز لأمن الطاقة» التابع لحلف الناتو، إلى طرح جملة من الخيارات بشأن الحروب منخفضة الكربون، تَمَثَّلَ أبرزها في تطوير واعتماد أنواع وقود بديلة، كالوقود الحيوي أو الوقود الاصطناعي، كما تبدو فكرة «إعادة التزود بالوقود» أحد أبرز الخيارات الجاذبة في هذا الإطار، وهو النهج الذي بدأت الولايات المتحدة تتبعه بالفعل في مبادرتها «الأسطول الأخضر العظيم»، والتي كشفت فيه عن إمكانية تزويد مجموعة حاملة الطائرات الضاربة بالوقود الحيوي المتقدم. وعلى المنوال ذاته، تمكنت القوات الجوية الملكية للمملكة المتحدة من تزويد طائراتها العسكرية الكبيرة بوقود الطيران المستدام.
كيف يمكن أن تؤثر «الحرب منخفضة الكربون» على مستقبل التنافس الجيواستراتيجي؟
لا تزال هناك حالة من الغموض التي تهمين على مستقبل العمليات العسكرية في ظل التغيرات المناخية الراهنة والتوجهات الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية، فعلى الرغم من تعدد الدراسات الغربية في هذا الشأن، فإن أغلبية هذه الدراسات لم تتمكن بعد من حسم الجدل المرتبط بكيفية تعامل الجيوش مع التحديات الخاصة بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والانعكاسات المحتملة لذلك.
وتجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب التأثيرات الأمنية للتغيرات المناخية، فثمة مخاطر جيوسياسية وأمنية تتعلق بنشر تقنيات المناخ الناشئة، على غرار خيارات الهندسة الجيولوجية الشمسية، وهو ما بدأت بعض الأدبيات في تسميته بـ«حرب المناخ الثانية»، باعتبار أن الحرب الأولى للمناخ كانت حرباً ناعمة ترتكز على الأفكار والمعرفة، أما الحرب الثانية فلا يتوقع أن تكون حرباً باردة كالأولى، بل يرجح أن تنطوي على صراعات عسكرية أو حروب هجينة. وقد ذهبت بعض التقديرات إلى اعتبار الانبعاثات السلبية وخيارات الهندسة الجيولوجية كعمود فقري مستقبلي لمجتمع منخفض الكربون والوصول إلى هدف صافي انبعاثات كربونية، نظراً لكون هذه الخيارات لا تحتاج إلى عمل وتنسيق عالمي، بل يمكن القيام بها من قبل مجموعة أصغر من الفواعل الدوليين. وبينما تعد الهندسة الجيولوجية أداة فعلية في الحروب المقبلة، لكنها تبدو أقل احتمالية في الوقت الحالي، بيد أن الصراع المحتمل لوقف نشر الهندسة الجيولوجية هو الأكثر احتمالية.
ويتسق ذلك مع تقرير نشره «مرصد الدفاع والمناخ» الفرنسي في نوفمبر 2023، والذي كشف عن عدة سيناريوهات محتملة تتعلق بمستقبل الصراعات المحتملة نتيجية خيارات الهندسة الجيولوجية ودورها في التعامل مع التغيرات المناخية، يتمثل السيناريو الأول في قيام الولايات المتحدة بشكل منفرد بتقنية «حقن الهباء الجوي الستراتوسفيري»، ما يدفع القوى الدولية الأخرى، لا سيما الصين وروسيا، إلى التهديد باللجوء للتدخل العسكري ضد هذه الخطوة الأمريكية. أما السيناريو الثاني فيتمثل في قيام الصين بإطلاق مشروعها «Arctic X» والذي يهدف لزيادة سطوع السُّحُب البحرية فوق القطب الشمالي، ومن ثم خفض كمية الأشعة الشمسية التي تصل إلى كوكب الأرض، إلا أن هذا المشروع سيلقى معارضة قوية من قبل روسيا، والتي تنظر إلى ذوبان الجليد في غرينلاند وبحر بارنتس كفرصة لاستخدام القطب الشمالي كطريق شحن تجاري، ناهيك عن الثروات الطبيعية الموجودة في هذه المنطقة.
وحتى الآن، لا يزال الإبلاغ عن الانبعاثات الكربونية العسكرية أمراً طوعياً، وليس إلزامياً في أغلب الدول، إلا أنه ربما يصبح من الصعب على نحو متزايد الحفاظ على هذا الموقف في ظل التنامي الملحوظ والمستمر في الظواهر الجوية القاسية والمتطرفة، رغم أن العديد من الالتزامات الدولية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة قد لا تكون قابلة للتنفيذ بشكل صارم.

هل تغير الحرب منخضفة الكربون من قواعد اللعبة القائمة؟
في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الجيوش للتعامل مع التغيرات المناخية، تعمد وزارات الدفاع حالياً إلى وضع ميزانية للتكيف مع هذه التغيرات، وهو ما يتجسد في حالة الولايات المتحدة الأمريكية، فقد خصصت وزارة الدفاع خلال السنة المالية 2022 نحو 617 مليون دولار للسياسات الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها المحتملة.
وفعلياً، ينطوي خفض الانبعاثات الكربونية على مجموعة من التحديات والفرص لوزارات الدفاع المختلفة، فمن المرجح أن تختار بعض القوى الاحتفاظ بالقدرات التقليدية الغنية بالكربون، كالدبابات والطائرات المقاتلة، لحين نفاد الوقود الأحفوري، فخلال العقد الجاري يبدو من الصعب الحفاظ على القدرات التشغيلية مع تقليل الانبعاثات الكربونية، ما يعنى الحاجة إلى بعض التنازلات من قبل قطاع الدفاع.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من البصمة الكربونية للجيوش يأتي بالأساس من المركبات وأنظمة المنصات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود الأحفوري. لكن ربما تكون المركبات البرية هي الأكثر سهولة في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث تواجه القوات البحرية والجوية مشكلات أكبر بسبب منصاتها الأكبر. وتشمل الخيارات المطروحة لتقليل الانبعاثات الكربونية بشكل كبير الدفع نحو استخدام أنواع الوقود البديلة وأنظمة الدفاع البديلة وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، فضلاً عن استخدام المنصات غير المأهولة والتدريب الاصطناعي.
وفي هذا السياق، بدأت بعض الجيوش الأوروبية العمل على تقليل الانبعاثات الصادرة عن المنشآت العسكرية، والتوسع في الاعتماد على شبكات الطاقة الصغيرة في توفير خيارات الاكتفاء الذاتي، بل والمساهمة في توليد الطاقة على المستويات الوطنية، وذلك من خلال إيجاد حلول مبتكرة لتخزين الطاقة بشكل آمن، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد الدفاعية لمواجهة التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وفي هذا الإطار، بدأت بعض الدول الغربية في تطوير أسلحة وذخيرة خضراء، وكانت الولايات المتحدة قد بدأت برنامجها لتصنيع ذخائر غير ضارة بالبيئة منذ عام 1994، وأنتجت طلقات من عيار 5.56 ملم، كما عمد الجيش الأمريكي بداية من عام 2017 إلى البحث عن ذخائر قابلة للتحلل للاعتماد عليها في التدريب.
وثمة تساؤل رئيسي يواجه الجيوش التي تتبنى نهج الحرب منخفضة الكربون، تتمثل في احتمالية مواجهة أعداء ذوي نسبة عالية من الكربون في ساحة المعارك، وفي هذا الإطار كشفت بعض التقارير البريطانية أن القوى البرية المكهربة (منخفضة الكربون) لن يكون بمقدورها مجاراة مستويات القوة والقدرات التي تمتلكها القوات الأحفورية، ما يعني أن الدول التي تتجه نحو الحرب منخفضة الكربون ستحتاج إلى إعادة النظر في عقيدتها القتالية. من ناحية أخرى، يمكن أن تعيد الحرب منخفضة الكربون هيكلة قواعد اللعبة من منظور آخر يتعلق بسلاسل التوريد ومصادر الطاقة، فعلى سبيل المثال أدت الحرب الروسية – الأوكرانية إلى دفعة جديدة للجيوش الأوروبية نحو التخلي عن الوقود الأحفوري بهدف تقليل الاعتماد على الامدادات الروسية من الغاز الطبيعي والنفط. لكن على الجانب الآخر، سيؤدي التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة للوقود الاحفوري إلى زيادة الحاجة إلى المعادن النادرة التي تنتج روسيا منها كميات كبيرة، ما يعني تعزيز دور موسكو في هذا الأمر أيضاً.
التحديات المحتملة للحروب منخفضة الكربون
بينما تتجه وزارة الدفاع الأمريكية، التي تعد أكبر مستهلك للطاقة في الحكومة الفيدرالية الأمريكية، نحو التوسع في كهربة أنشطتها العسكرية، بما في ذلك تشغيل الدبابات والمركبات والسفن والطائرات، بل إن الوزارة كانت قد درست فكرة نشر مفاعلات نووية صغيرة في أي ساحات حروب مستقبلية من أجل توفير الطاقة اللازمة، بيد أن ثمة تقارير أمريكية كشفت عن جملة من التأثيرات الاستراتيجية التي ينبغي أخذها في الاعتبار، ففي كل مرة تقوم فيها الجيوش بتغيير أنظمة الطاقة، تكون هناك تداعيات جيواستراتيجية هائلة، وهو ما ينعكس بوضوح في قرار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ونستون تشيرشل، بتحويل مصدر الطاقة الرئيسي للبحرية الملكية البريطانية من الفحم المنتج محلياً إلى النفط المستورد. وعلى المنوال ذاته، بينما يعد تنوع مصادر الطاقة في الولايات المتحدة أحد أبرز محددات قوتها وأمن الطاقة لديها، فإن اتجاه واشنطن نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري ستكون له تداعيات على تقليص هذا التنوع في مصادر الطاقة لديها، ومن ثم التأثير على أمنها الطاقوي، حيث سيجعل الولايات المتحدة أكثر اعتماداً على الجهات الأجنبية في استيراد المعادن اللازمة لأنظمة الكهرباء. من ناحية أخرى، فإن التركيز على إنتاج الكهرباء كمصدر رئيسي للطاقة، وما ينطوي عليه من تعزيز ترابط أنظمة الطاقة، يزيد من احتمالات وقوع هجمات سيبرانية، ناهيك عن التهديدات المحتملة لمحطات الطاقة الكهرومائية والنووية. يضاف لذلك إشكالية أخرى تتعلق بصعوبات الحصول على الكهرباء في ساحات المعارك، كون خطوط الكهرباء لا تكون فعالة سوى لمسافات قصيرة. ناهيك عن التحديات الخاصة بالوقت اللازم لشحن البطاريات مقابل التزود بالوقود، والذي يمكن أن يخلق تحديات إضافية على فاعلية الجيوش. وبالتالي على الرغم من الآثار الإيجابية التي تحققها الحروب منخفضة الكربون، فإنها تنطوي أيضاً على تحديات عدة، ما يعني الحاجة لمزيد من الدراسات والمناقشات قبل اتخاذ القرار الأخير.
وفي الختام، يبدو أن ثمة استجابة ملحوظة حالياً من قبل الجيوش الغربية المختلفة للطريقة التي يعيد بها التغير المناخي من تشكيل مجال وبيئة عمل القوات العسكرية، ودور الأخيرة في التعامل مع التغيرات المناخية. وتعمل المؤسسات الدفاعية الأوروبية حالياً بشكل متزايد على دمج التغيرات المناخية في سياساتها وخططها الاستراتيجية، حيث تحدد معظم الاستراتيجيات الغربية أهدافاً مؤقتة قابلة للتحقيق من أجل خفض الانبعاثات، فهي تركز في المدى المنظور على زيادة كفاءة اسخدام الطاقة في المنشآت والبنية التحتية، وتشغيل أسطول المركبات غير التكتيكية بالطاقة الكهربائية، فضلاً عن تركيب أنظمة الطاقة المتجددة، وكذا البدء في مشروعات تجريبية لدمج التكنولوجيا الجديدة كالهيدروجين والوقود الاصطناعي (أو الوقود الكهربائي.
» الأستاذ عدنان موسى (مدرس مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة(