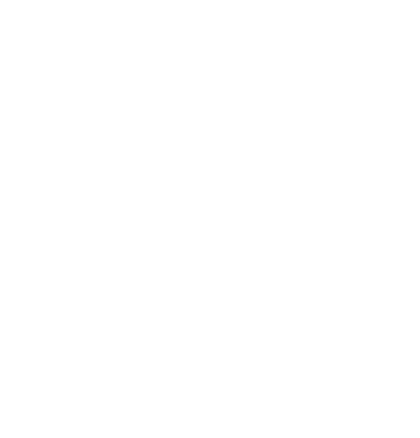تعتمد الجيوش الحديثة على بعض الأقمار الصناعية في طرق الحرب الحديثة، وأصبح الفضاء بمنزلة التل المرتفع جداً بنهاية الطريق، حيث الولايات المتحدة هي الملك المتوَّج عليه بلا منازع الآن، وإذ تسعى كل من الصين وروسيا بقوة إلى تحدي التفوق الأمريكي في الفضاء، عبر برامجهما الفضائية العسكرية الطموحة، تزيد مخاطر الصراع على السلطة وفرض النفـوذ من خطر اشتعال نزاع قد يشل البنية التحتية الفضائية لكوكب الأرض بأكمله.. وبالرغم من أنه قد يبدأ في الفضاء، فإن هذا النزاع قد يُشعل بسهولة حرباً شاملة على الأرض.

عبر عصور طويلة تطورت الأسلحة التي تستخدمها الجيوش، من المقذوفات الحجرية البسيطة في العصر الحجري القديم، إلى أسلحة الدمار الشامل في عالمنا الراهن، فما العوامل الرئيسية التي أدت إلى تطور التقنيات العسكرية؟ كشفت دراسة جديدة نُشرت نتائجها في دورية “بلوس وان” عن تلك العوامل، إذ تقول إن اختراع التقنيات الرئيسية للأسلحة وانتشارها يعتمدان على الاتصال بين المجتمعات المختلفة. أي أن تطوير الأسلحة في جوهره “تبادل ثقافي” بين الأمم، على حد ما يقول الأستاذ بكلية جورج براون، دانيال هوير، وهو المؤلف المُشارك في تلك الدراسة.
وقد يكون فراغ الفضاء الخارجي هو آخر مكان تتوقع أن تتنافس فيه الجيوش على المناطق المتنازَع عليها، إلا أن الفضاء الخارجي لم يعد فارغاً، ففي محيطه يدور حوالي 1300 من الأقمار الصناعية النشطة، تحيط بالكرة الأرضية في عش مزدحم من المدارات، من أجل توفير الاتصالات في جميع أنحاء العالم، وتحديد المواقع والملاحة، والتنبؤ بالأحوال الجوية ومراقبة الكواكب.
والتوترات المستمرة منذ مدة طويلة تقترب الآن من نقطة الغليان نتيجة العديد من الأحداث، من ضمنها الاختبارات الأخيرة والمستمرة لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية، والمحتمل إجراء الصين وروسيا لها، فضلاً عن الفشل في محادثات تخفيف حدة التوتر بالأمم المتحدة منذ شهر يوليو 2015.
وتسلط العديد من النظريات التطورية الثقافية الضوء على أن التقنيات العسكرية حالة ثقافية خاصة، بحجة أن التحسينات الحادة في كلٍّ من القدرات الهجومية للتقنيات جنباً إلى جنب مع التكتيكية والتنظيمية المصاحبة أدت إلى “الثورات العسكرية التي كان لها بدورها تداعيات كبيرة على صعود تشكيلات الدولة على الصعيد العالمي وانتشارها.
وقد شهدت ميادين التسلح تطوراً متراكماً من ناحية الكم والنوع، مدفوعةً بالتطور التكنولوجي، وما يسببه من تغير في آليات ووسائل الاشتباك الميداني في مسارح العمليات العسكرية. وثمة اعتقاد لدى معظم الخبراء الاستراتيجيين أن التقنية هي العامل الأبرز في تصنيف قوة الجيش ومدى قدرته على إحداث النصر العسكري، وبالتالي حسم الموقف سياسياً، وإن اختلفت طبيعة الاشتباك ووسائل التعبير عن تناقض المصالح.
ثورة مفاهيم الاستراتيجية العسكرية
وقد أحدثت هذه التغييرات الجذرية منذ منتصف القرن الماضي، ثورةً في مفاهيم علم “الاستراتيجية العسكرية” فاقت ما تراكم منذ بدء تشكل ملامح هذا العلم. فمفاهيم مثل “الردع النووي” و”سباق التسلح” و”التفوق الجوي” و”الحرب الخاطفة” و”الحرب بالوكالة”، لم تظهر إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وظهر مصطلح “حرب النجوم” أثناء الحرب الباردة. وهو اسم أطلق على مبادرة الدفاع الاستراتيجي لعسكرة الفضاء، في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريجان (في 23 مارس 1983) لاستخدام الأرض والنظم الفضائية وحماية الولايات المتحدة من هجوم بالصواريخ الباليستية النووية. ووضع هذا المشروع في أقصى درجات السرية. وقد جعلت “الميديا” مبادرة ريجان شغلها الشاغل والخبر الأول، ثم في مرحلة أخرى، دفن في الظل وأمسى كأن لم يكن.
وفي مبادرة الدفاع الاستراتيجي لعسكرة الفضاء الأمريكية، ذكرت الأخبار في 30 أغسطس 2019، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تشكيل قيادة عسكرية للفضاء، تكون مسؤولة عن ضمان هيمنة الولايات المتحدة، التي تهددها الصين وروسيا، في هذا المجال العسكري الجديد، رغبة منه في تأمين الجاهزية في حال نشوب حرب النجوم.
ومن جانبها، أطلقت الصين ما سماه العديد من الخبراء تجارب إضافية للأسلحة الحركية الأرضية المضادة للأقمار الصناعية، ويعود تاريخ إجراء آخر اختبار صيني إلى 23 يوليو من عام 2014، ومع ذلك يصر المسؤولون الصينيون على أن الغرض الوحيد من الاختبارات هو الدفاع الصاروخي السلمي وإجراء التجارب العلمية. لكن في أحد الاختبارات، في مايو 2013، انطلق صاروخ إلى ارتفاع 30 ألف كيلومتر فوق الأرض، مقترباً من الملاذ الآمن للأقمار الصناعية الاستراتيجية في المدار الأرضي المتزامن.
ويصر المسؤولون الصينيون على أن أنشطتهم العسكرية في الفضاء هي تجارب علمية سلمية بسيطة، بينما التزم المسؤولون الروس الصمت في معظم الأحوال، من الممكن ببساطة رؤية ما تفعله الدولتان كمجرد رد على ما تعتبرانه تطويراً سرياً لأسلحة فضائية محتملة تقوم به الولايات المتحدة واقعياً، فإن أنظمة الدفاع الصاروخية الأمريكية، بطائراتها الفضائية من طراز X-37B وحتى مركبة GSSAP الفضائية، يمكن استخدامها بسهولة كأسلحة لحرب فضائية، على الرغم من تخصيصها ظاهرياً للحفاظ على السلام.
لقد سعت روسيا والصين لسنوات من أجل التصديق على معاهدة ملزِمة قانونياً بالأمم المتحدة لحظر الأسلحة الفضائية، وهي المعاهدة التي رفضها مسؤولون أمريكيون وخبراء خارجيون مراراً وتكراراً، ونعتوها بالعقيمة والمخادعة.
ثورة الذكاء الاصطناعي العسكري
في احتفالٍ أقيم بهذه المناسبة في البيت الأبيض في أغسطس 2019، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تأسيسَ “القيادة الفضائية الأمريكية” كفرع مستقل عن القيادة الجوية، لتصبح هذه القيادة المستحدثة سادس فروع القوات المسلحة الأمريكية. ووفقاً لما قاله ترامب في الاحتفال، “إن تأسيس هذه القيادة يهدف للحفاظ على “هيمنة” الولايات المتحدة في الفضاء، وللتفوق على منافسي أمريكا” في إشارة إلى الصين وروسيا التي حذرت من “عسكرة الفضاء الخارجي” ومن اضطرارها للرد بالمثل بإجراءات وتدابير متطابقة.

وفي دلالة واضحة تؤكد ولوج التنافس العسكري العالمي مرحلة فضائية جديدة، كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أن الوصول المؤكد إلى الفضاء، من خلال مجموعة كاملة من العمليات العسكرية هو أمر حيوي، معتبراً أن هذه الخطوة تضع الولايات المتحدة على مسار الحفاظ على ميزة تنافسية في هذه الحرب الحاسمة.
وبالإطلاع على وظيفة “حرب النجوم الجديدة” وما تحمله من تأثيرات مباشرة على التحركات الميدانية الأرضية، يتبين مدى جوهرية السيطرة على النطاق الفضائي لأي دولة تسعى إلى تحقيق مكاسب استراتيجية عظمى. فتحييد الأقمار الصناعية العسكرية الخاصة بدولة ما، يفقدها تماماً القدرة على التحكم بكل العمليات المتصلة بهذا القمر على اليابسة والبحر والجو. ويؤدي اختراق الموجات التي يعمل بها قمر ما، إلى كشف الأوامر والعمليات التي يديرها، أو إلى التشويش الإلكتروني على هذه العمليات. وفي مرحلة ما قد يكون ممكناً التحكم والسيطرة على قمر صناعي معادٍ وتوظيفه للقيام بمهام “تدمير ذاتي”.
بالإضافة إلى الأخطار الصادرة من الفضاء الخارجي، تبرز ضرورة مواجهة التحديات الصادرة من الفضاء السيبراني، والتي لا تقتصر فقط على الجوانب العسكرية، وإنما تمتد أيضا للجوانب الشخصية (خصوصية المستخدم) والجوانب الاقتصادية. فقد قدرت شركة أمن الإنترنت “McAfee” في تقريرٍ نشرته في فبراير 2018، أن الكلفة السنوية للجرائم الإلكترونية على الاقتصاد العالمي، تبلغ 400 مليار دولار، وهو ما يقارب الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي مجتمعة.

وتذهب بعض العقائد العسكرية إلى تقييم عمليات الاعتداء السيبراني المُنظمة الصادرة من حكومات، على أنها عمل عدواني يستدعي رداً عسكرياً، استناداً إلى حق الدفاع عن النفس الذي أقرته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث يشير إلى أنه: “ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة..”. ولا يزال المشرعون القانونيون يحاولون وضع مواد قانونية محكمة تكيف الوضع القانوني للتعامل مع الهجمات السيبرانية الرسمية أو شبه الرسمية.
وفي سبتمبر 2019 خطت وزارة الدفاع الفرنسية خطوة غير مسبوقة بإعلانها تطبيق القانون الدولي في الفضاء السيبراني، حيث تعتبر فرنسا أن أي عمل سيبراني عدائي، هو بمثابة اعتداء على سيادتها يستوجب رداً وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، خاصة إذا كان هذا العمل صادراً من أي حكومة، سواء بصورة مباشرة أو بتواطؤ غير مباشر منها، ضد البنية التحتية الرقمية الفرنسية، أو نتج عنه دمار اقتصادي أو مادي أو تأثير على قطاع حيوي، أو نتج عنه خسائر في الأرواح.
إلا أن ما يصعب تحديده وتختلف عليه دول عديدة، هو “العتبة” التي بتجاوزها يكون استخدام القوة الإلكترونية، هجوماً مسلحاً “يشرعن” للدولة المُهاجَمة حق الدفاع عن النفس. فحتى يكون إعلان أي دولة شن عمل عسكري هو قرار “عادل”، يجب أن يكون ضمن ما اصطُلح على توصيفه قانونياً بظروف “Jus ad bellum”.

وتبعاً لقرارات تاريخية صادرة عن محكمة العدل الدولية، تعتبر الهجمات المسلحة أخطر أشكال استخدام القوة. وهو ما يضع قيوداً صارمة أمام أي دولة ترى أن لها الحق بالرد عسكرياً على هجمات سيبرانية. وباتجاه معاكس، قد تستخدم دولة ما الهجمات السيبرانية للرد على هجوم عسكري تقليدي. فبعد إسقاط المضادات الإيرانية للطائرة الأمريكية المسيرة “جلوبال هوك RQ-4A” في يونيو 2019، تناقلت وسائل إعلام أمريكية تنفيذ القيادة السيبرانية الأمريكية “USCYBERCOM” هجمات إلكترونية واسعة ضد شبكات اتصال عسكرية تستخدم لإطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى تنفيذ هجوم إلكتروني متزامن ضد شبكة تجسس واستطلاع إيرانية مكلفة بمراقبة الملاحة في مضيق هرمز، ويُعتقد أن لها دوراً في الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في خليج عُمان في منتصف يونيو 2019.
الألغام الفضائية
هذا يعني أن الرد على اعتداء ملموس، قد يتم في العالم السيبراني الذي لم يعد محسوساً فقط، وإنما يقع في العمق من البنى التحتية الرقمية-المادية. وبذوبان الحواجز بين ما هو رقمي وما هو مادي، وبين ما هو اصطناعي وما هو عضوي، يجادل مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، Klaus Schwab، أن الثورة الصناعية الرابعة تتشكل واعدةً بدرجة تغيير أكبر من تلك التي أحدثتها الآلة البخارية، والكهرباء، والأنظمة الحاسوبية.
إلا أن ما يجب التحذير منه، هو الطفرة التي تحدثها “الثورة الصناعية الرابعة” في مجال الذكاء الاصطناعي العسكري الذي يقترب شيئاً فشيئاً من تمكين الدولة المتفوقة تقنياً لحسم المعركة قبل أن تبدأ ميدانياً، في تنفيذ ساحر لنصيحة أحد رواد الاستراتيجيات العسكرية ومؤلف كتاب فن الحرب، صن تزو (551-496 قبل الميلاد) الداعي إلى “الفوز دون نزال”. فمعارك الفضاءين، الخارجي والسيبراني، ترسم ملامح الاشتباك الفعلي القادم الذي بدأت ملامحه تبرز للعيان.
إن احتمال نشوب حرب في الفضاء ليس جديداً. فبدافع الخوف الأمريكي من الأسلحة النووية السوفييتية التي تنطلق من مدار حول الأرض، بدأت الولايات المتحدة في اختبار أسلحة مضادة للأقمار الصناعية في أواخر خمسينات القرن الماضي، حتى إنها اختبرت القنابل النووية في الفضاء قبل حظر أسلحة الدمار الشامل المدارية، بعد معاهدة الفضاء الخارجي بالأمم المتحدة لعام 1967.
وبعد الحظر، أصبحت المراقبة الفضائية عنصراً حاسماً في الحرب الباردة، مع الأقمار الصناعية التي أصبحت جزءاً من أنظمة الإنذار المبكر المتطورة، والمتأهبة لرصد انتشار الأسلحة النووية الأرضية أو إطلاقها طوال أغلب فترات الحرب الباردة، وقد عمل الاتحاد السوفييتي على تطوير واختبار “الألغام الفضائية”، وهي مركبات فضائية ذاتية التفجير يمكنها ملاحقة أقمار التجسس الصناعية الأمريكية وتدميرها عن طريق إمطارها بوابل من الشظايا.
بقلم / أ. د. نبيل سليم (باحث عسكري واستراتيجي)