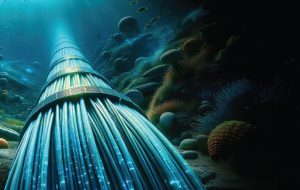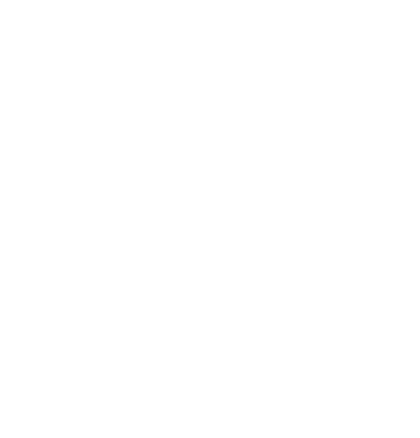الاستخدام المزدوج مصطلح يطلق على بعض المواد والمنتجات التي يمكن أن تستعمل في مجالات مدنية أو عسكرية، وغالباً ما يكون تصديرها خاضعاً لقوانين ورقابة خاصة، وقد يكون محظوراً إلى دول بعينها، والدول المدرجة في بعض القوائم لا يمكنها الحصول على هذه المواد أو المنتجات. والكثير من الدول أصبحت أكثر اعتماداً على نفسها في تطوير تقنيات تستخدم في تصنيع الأسلحة غير التقليدية، والاستعانة بالمعدات مزدوجة الاستخدام، تحت غطاء الأنشطة العلمية والسلمية.
ولذلك، اتسعت خارطة انتشار هذه الأسلحة، وكذلك برامج انتاجها. ويتضمن هذا الانتشار الامتلاك السري وغير المشروع للمواد التي تتصف في طبيعتها بازدواجية الاستخدام، وغالباً ما يتم استيرادها لمشروعات البحوث والتنمية المشروعة، كإنتاج اللقاحات والأدوية والأسمدة، للتهرب من عمليات التفتيش الدولي.
والمجالان، المدني والعسكري، يقدمان حوافز قوية لتطوير تقنيات جديدة، فأينما تتفق المعايير العسكرية مع الاهتمامات المدنية، عادة ما يتسارع التقدم التقني. وإضافة إلى ذلك، فإن الابتكارات التي تشجعها المتطلبات العسكرية يمكن أن تتطور بدون معوقات السوق الطبيعية. فالعلماء يحتاجون المال والمختبرات، من أجل تطبيق نظرياتهم. ومن أهم الجهات التي تساهم في ذلك المؤسسات العسكرية، بصفة عامة. وعلى سبيل المثال، فإن تطوير تقنيات الطيران الحربي منذ الحرب العالمية الأولى، والمركبات المدرعة التي تصمد أمام قسوة البيئة الصحراوية، فضلاً عن السفن السريعة، جميعها تمت في مختبرات عسكرية، وكان هدفها حربياً، ولكنها انتشرت وباتت تستخدم في المجالات المدنية. فعند انتهاء العمل العسكري، تتحول بعض الشركات المصنعة لمواءمة إنتاجها للاستخدام المدني.
والابتكارات التي قدمت للعمل العسكري لم تتوقف عند الصناعات الثقيلة، بل امتدت حتى للطب نفسه، حيث وجدت الكثير من الأمصال العلاجية بفضل مختبرات عسكرية. وبعض التقنيات التي لم يتم تطويرها لأغراض عسكرية تم تحويلها لذلك. وعلى سبيل المثال، تم تطوير تقنية تعدين الحديد في البداية واستخدامها في تحسين وظيفة الأدوات الزراعية، مثل المحاريث، ولكن سرعان ما استُخدمت على نطاق واسع لصنع سيوف ودروع وأدوات حربية. ومادة الأمونيا التي تستخدم بكثرة لتخصيب الأراضي الزراعية استخدمت لإنتاج الأسلحة الكيميائية في الحرب العالمية الأولى. وخلال حقبة الحرب الباردة، أنفقت واشنطن وموسكو الكثير من الأموال لتطوير تقنيات الصواريخ التي تطلق المركبات الفضائية، للاستخدامات السلمية، مثل الاستشعار عن بعد، والاتصالات، والأرصاد الجوية، والملاحة، ثم استخدمت نفس التقنيات لتطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات. والدول التي تطور الصواريخ البالستية يمكنها ادعاء أن برامجها تهدف إلى تطوير صواريخ لإطلاق الأقمار الاصطناعية التي تستخدم للأغراض السلمية والعلمية. وأجهزة الرؤية الليلية المتطورة التي تستخدم في الحروب تخضع للحظر من جهة الدول المنتجة لها حتى لا تصل الى جنود الأعداء، أو يتم إنتاجها باستخدام أسلوب الهندسة العكسية. وهذه الأجهزة لها استخدامات مدنية عديدة، في مجالات التصوير، والطب، ومكافحة الحرائق، وغيرها.
التقنية النووية
تمثل التقنية النووية إحدى التقنيات الأكثر اهتماماً في القضايا الإقليمية والدولية، حيث تزداد المطالب عليها تحت عناوين مختلفة، منها الحاجة إلى مصادر جديدة ومتجددة للطاقة، على سبيل المثال. ولكن، من ناحية أخرى، فإن عدداً من الدول التي ذهبت باتجاه الخيار النووي العسكري، أو امتلكته بالفعل، تراجعت عنه، ومن هذه الدول: جنوب إفريقيا، والبرازيل، والأرجنتين. ومن الملاحظ سهولة الانتقال والتهرب من الرقابة في عملية التحول عبر تخصيب اليورانيوم من النووي المدني إلى النووي العسكري. فجهاز الطرد المركزي، مثلاً، يمكن استعماله في المجال الطبي، ويمكن استعماله أيضاً لتصنيع اليورانيوم المخصب لأغراض عسكرية. وأعمدة الجرافيت يمكن استعمالها لضبط أو التحكم في المفاعلات النووية، أو استعمالها في مجالات مدنية. والقنبلة الاشعاعية، والتي يطلق عليها «القنبلة القذرة» (تسمى علمياً «جهاز تشتيت الإشعاع» Radiological Dispersal Device: RDD) عبارة عن مواد نووية مشعة، يمكن وضعها في متفجرات تقليدية، ويؤدي الانفجار الناتج عن هذه المتفجرات إلى انتشار الإشعاع المتولد عن المواد النووية على مساحات كبيرة. وتبخر القنبلة المتفجرة النظائر السامة، أو ترذذها وتدفعها إلى الهواء المحيط. ويمكنها أن تحدث ضرراً نفسياً هائلاً عن طريق استغلال الخوف من الإشعاع غير المرئي، أو مشكلة اقتصادية بجعلها بعض المناطق محظورة لفترة طويلة. ويعتبر الحصول على النظائر المشعة أمراً سهلاً بسبب انتشارها الواسع في الأغراض العلمية والطبية، مثل العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، أو في الأغراض الصناعية، مثل قتل البكتيريا في الأغذية، وتعقيم المنتجات الطبية، وفحص وصلات اللحام، وإجراء الأبحاث في الفيزياء والهندسة النووية. وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن معظم دول العالم لديها المواد المشعة اللازمة لصنع قنبلة قذرة، وتفتقر إلى وسائل السيطرة الكافية لمنع سرقة هذه المواد.

تقنيات الكمبيوتر
في بداية النصف الثاني من القرن العشرين، كانت المؤسسات العسكرية هي الداعم الرئيسي للبحوث والتطوير للصناعات الإلكترونية. وبعض أشكال التفوق التقني الرئيسية في هذه المجالات تم تطويرها أولاً من أجل المنظومات العسكرية، ومنها أجهزة وشبكات الكمبيوتر فائقة السرعة، حيث سعى العلماء لزيادة قوة المعالجة في أنظمة الكمبيوتر من أجل تطوير أسلحة ذات قدرات تدميرية هائلة، وبصورة خاصة، الأسلحة النووية. وكان الهدف الأول من أنظمة السوبر كمبيوتر هو تطوير هذا النوع من الأسلحة، إلى درجة جعلت الولايات المتحدة تصنف أنظمة الكمبيوتر على أنها من المنتجات ذات الطابع الاستراتيجي، التي تفرض قيوداً كثيرة على تصديرها. غير أن أجهزة الكمبيوتر المطورة لأغراض مدنية باتت أكثر فاعلية من تلك المطورة للأغراض العسكرية، في كثير من الأحيان. وهناك عدد من الشركات التي قد لا تكون مهتمة كثيراً بالعقود الدفاعية، لأن هذه العقود ذات هوامش أرباح منخفضة، وتعاني بطئاً في عمليات اتخاذ القرارات، وتأمين المشتريات، وصعوبة التعامل مع الأطر التنظيمية لها.
وعلى سبيل المثال، قامت الولايات المتحدة بتحديث الطائرات المجهزة بنظام الرادار «جستارز» Joint Surveillance Target Attack Radar System: JSTARS ورفعها إلى مستوى فئة Block 20 من خلال استبدال أنظمة الكمبيوتر المتقادمة بمكونات جاهزة في السوق المدنية. ويتميز التصميم الجديد لبرنامج التحديث بهيكل مدمج للكمبيوتر، ومعالج للإشارات يعتمد على مكونات جاهزة من السوق المدنية، ويمكن تحديثه بسهولة، مما يسمح بالحصول على معدات وبرمجيات بتكاليف متدنية، تلبي متطلبات النظام لما بعد عشرين سنة قادمة.
وتعتبر المحاكاة بالكمبيوتر Computer Simulation أحد الأمثلة على التقنية مزدوجة الاستخدام، فالخطوط الجوية المدنية تستخدم المحاكيات لتدريب الطيارين، كما يستخدمها الطيارون العسكريون. والمحاكيات بالنسبة للأسلحة العسكرية لا تؤدي فقط إلى إنقاص تكاليف التدريب، بل تسمح أيضاً بالتدريب على أوضاع القتال، التي يكون من الخطر الإفراط في إجرائها ميدانياً. فتقنية المحاكاة تسمح بعمليات محاكاة تشمل أكثر من طائرة أو دبابة واحدة، وتبين عمليات اشتباك بصورة متكاملة، وتستخدم في تصميم واختبار الأسلحة الجديدة، كما تستخدمها الشركات المدنية في تصميم الدوائر الإلكترونية، وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الاتصالات، بل والسيارات والطائرات الجديدة، قبل بناء النموذج الأولي Prototype منها.
الذكاء الاصطناعي
يعتبر الذكاء الاصطناعي أحد فروع علم الكمبيوتر الذي يُعنى بدراسة وتصميم العميل الذكي، الذي يستوعب بيئته، ويتخذ القرارات التي تزيد من فرصته في تحقيق مهمته. فهو علم وهندسة صنع الآلات الذكية القادرة على تفسير البيانات الخارجية بشكل صحيح، والتعلم من هذه البيانات، واستخدام ذلك لتحقيق أهداف ومهام محددة، فيما يشبه محاكاة القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، والتي تتسم بالتعلم، والاستجابة، والاستنتاج.
واستخدمت تقنية الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من المجالات المدنية، من بينها النظم الخبيرة Expert systems، والتحكم الآلي، ومحركات البحث على الإنترنت، ومعالجة اللغات الطبيعية، وتمييز الأصوات، وتحليل الصور، وألعاب الفيديو، والتشخيص الطبي. ويمكن للروبوتات المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي دعم الإنتاج في المصانع، دون الحاجة إلى التدخل البشري في عمليات التصنيع والتغليف والتعليب، وغيرها. وتَعِد الاستخدامات العسكرية لتقنية الذكاء الاصطناعي بفرص واعدة في مجالات تحسين قدرات كشف الأهداف، وتمييزها، وتتبعها، وتدميرها. وسيكون لكل هذا آثار عميقة على طبيعة الحرب في المستقبل بعد توفير قدرات مميزة من حيث سرعة معالجة المعلومات، والأتمتة لمزيج من منصات الأسلحة وأنظمة المراقبة المأهولة وغير المأهولة، واتخاذ القرارات في أنظمة القيادة والتحكم.
التقنية الرقمية
تشكل التقنية الرقمية Digitization النقلة النوعية في نظم المعلومات والاتصالات، ويبرز فيها التماثل بين الشبكات العسكرية المستندة إلى هذه التقنية والشبكات المعدة للاستخدام المدني. وتتميز أنظمة المعلومات المدنية عادة بمستوى مرتفع من جودة النوعية يدفع المؤسسات العسكرية إلى استعمالها. وشهد عقد التسعينات من القرن الماضي أكبر تحول نحو الثورة الرقمية داخل المؤسسات العسكرية لتحويل جميع أدواتها وأجهزتها لتعمل بالأسلوب الرقمي Digital. والتوجه الرقمي في بث المعلومات وتحليلها، يفتح حقلاً جديداً، يسير في عدة اتجاهات متكاملة، مدنية وعسكرية. وأصبحت المعطيات الرقمية عناصر ضرورية في كل أنظمة التسليح، حيث تعتبر المعركة الرقمية تطبيقاً «ذكياً» لتقنية المعلومات، لتحقيق التفوق فى ساحة المعارك، بدون إنشاء منصات جديدة للأسلحة، وهذا يوفر لساحة المعارك قدرة شبيهة بقدرة الإنترنت بعد أن بدأت التقنية الرقمية للمعطيات تتوسع تدريجياً لتشمل مختلف الأنشطة العسكرية التي تعتمد على أجهزة الكمبيوتر الرقمية، وذلك في كل المجالات، من تحليل وتصنيف المعلومات، إلى وضع الخطط القتالية، الى إجراء الاتصالات، وغير ذلك.
تقنية الليزر
تستخدم تقنية الليزر في العديد من التطبيقات المدنية، في مجالات الطب، والاتصالات، والأبحاث العلمية والهندسية، وفي الصناعات الإلكترونية، وفي أجهزة قياس المسافات الدقيقة، وفي لحام المواد الصلبة. وشهد الجانب العسكري تطوراً واسعاً يشير إلى المضي في الاتجاه نفسه، من جهة، وإلى المزيد من التنوع، من جهة ثانية، وقد تكون الظاهرة الملفتة للنظر في هذا السياق، اختراق تقنية الليزر تدريجياً، للأسلحة أو الأنظمة أو المكونات، التي تتصف بصغر الحجم نسبياً. وشهدت الحروب الحديثة العديد من استخدامات أشعة الليزر، سواء لإضاءة الأهداف لتوجيه المقذوفات نحوها، أو لقياس مسافة هذه الأهداف وتمييزها من خلال الرادار الليزري LADAR، وذلك إضافة إلى ما يجري من تجارب في مجال أسلحة الطاقة الموجهة على استخدام القدرة العالية لشعاع الليزر في تدمير الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. ولا تكمن خطورة أشعة الليزر في صعوبة إعاقتها، بل في أنها تستطيع أن تشل فعالية وسائل الرؤية المختلفة، سواء بالعين المجردة، أو بالأجهزة البصرية وأجهزة التكثيف الضوئي، فالليزر قادر على تعطيل أو تدمير أي جزء بصري حساس.
أمريكا في المقدمة
كانت وكالة مشروعات البحوث المتقدمة «داربا» الأمريكية رائدة في تقدم تقنيات الاستخدام المزدوج، مثل تقنيات شبكات الكمبيوتر المتقدمة، ومنها شبكة «أربانت»، وهي السلف لشبكة الإنترنت، وكذلك المعالجات المتوازية للمعلومات. وأذنت الإدارة الأمريكية للوكالة بإنفاق مبالغ كبيرة، على شكل اعتمادات مالية للقطاع الخاص، لإنفاقها على البحوث في مجال هذه التقنيات. وبدأت معامل الأسلحة القومية الأمريكية بتشجيع أنشطة مماثلة لتقدم التعاون بين الحكومة والصناعة. فأعلن معمل لوس ألاموس القومي الأمريكي (وهو مهد ولادة القنبلة الذرية) أنه سيقوم بأول اتفاق تجاري من نوعه، بمساعدة شركة خاصة، لتحسين إنتاج لوحات الدوائر المطبوعة. وفي هذا الاتجاه، أعلن المعمل أنه سيعير تقنية أشعة سينية، كانت قد طورت لبحوث الأسلحة النووية، إلى شركة تصنع آلات تصوير الثدي لتشخيص سرطان الثدي لدى النساء، وأعلنت وسائل الاعلام آنذاك «أن التقنية الدفاعية قد تحولت إلى حرب ضد سرطان الثدي».
وشجعت المتطلبات العسكرية الانتشار السريع للتقنيات الجديدة في الولايات المتحدة. فمثلاً، عملت شركتان على تطوير أجهزة كمبيوتر «مارك» لحساب البحرية الأمريكية في عام 1937. وعملت معامل شركة «بيل»، بدءاً من عام 1939، في مجال الكمبيوتر لحساب المدفعية بالجيش الأمريكي. كما دعم الجيش الأمريكي أيضاً عام 1944 برنامج الكمبيوتر «إينياك»، وهو أول كمبيوتر رقمي، في احدى الجامعات. ومن أجل برنامج الصاروخ البالستي العابر للقارات «أطلس»، تم تطوير برامج التصميم بمعاونة الكمبيوتر في أواخر خمسينات القرن العشرين. وشهدت سنوات الحرب العالمية الثانية العديد من الابتكارات في مجالات تقنية مدنية عديدة، استند بعضها إلى أبحاث سبقت الحرب، ولكنها لم تكتمل حتى مولتها واشنطن لمساعدة قوات الحلفاء.

التساهل مع المواصفات العسكرية
تتضمن كل من التقنية العسكرية والمدنية معايير خاصة، وأخرى متداخلة، وتتميز معايير التقنية في منطقة التداخل بمعدل تطور أسرع، حيث تتمتع التقنية التي تقع مواصفاتها في هذه المنطقة بأن لها فائدة لكلا القطاعين، العسكري والمدني، وتحوز على اهتماماتهما، بينما لا تحظى المواصفات الواقعة خارج هذه المنطقة إلا باهتمام أقل، وبالتالي، دعم وتقدم أقل. ويمكن للقطاع العسكري الحصول من القطاع الصناعي المدني على كثير من القدرات الجديدة، ولاسيما في قطاعي المعلومات والإلكترونيات، حيث تؤدي المنافسة فيه دوراً كبيراً في دفع عجلة البحث والتطوير. فعناصر البحوث الأساسية والتطبيقية واحدة، ويتركز الفرق في إضافة مواصفات خاصة بالدفاع، وهو ما يضيف أعباء إضافية على التكلفة. وغالباً ما كان العسكريون لا يرضون بمواصفات التقنية المدنية، ويصرون على تحقيق المواصفات العسكرية، ونتج عن ذلك ضعف مستوى الاستفادة من التقنية المدنية في التطبيقات العسكرية. ولكن العقود الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في بعض التقنيات المدنية، مما جعل العسكريين يعيدون التفكير في تمسكهم بالمواصفات العسكرية، وبجدوى ما ينفق على تطوير التقنيات التي تحقق هذه المواصفات. وبدأ الاتجاه يتزايد للاستفادة من التقنية المدنية في التطبيقات العسكرية، وأصبحت معظم التقنيات الحديثة تستخدم في المجالين. وأكبر مجال يشهد على ذلك هو مجال تقنية المعلومات.
ولكن، من ناحية أخرى، فإن استعمال المؤسسات العسكرية المتزايد للتقنيات المدنية الجاهزة في مجال نظم المعلومات يزيد من أخطار التعرض للفيروسات، وكذلك من فرص استخدام أنظمة مألوفة ذات نقاط ضعف معروفة. وسيكون هناك مبرر يسوغ استخدام شبكات منفصلة لأجل تدفق المعلومات البالغة الحساسية واتصالات القيادة والتحكم الرئيسية، بالرغم من الضغوط التي تمارس لتحقيق وفر في التكلفة.
وفي عام 1994، بدأ البنتاجون بتعديل سياسة المواصفات العسكرية، بحيث لا يجوز أن تستخدم إلا في أضيق الحدود، وأعطى ذلك للمسؤولين سلطة شراء المكونات المدنية، ما لم يكن هناك سبب قوي للتمسك بالمواصفات العسكرية. وبذلك غيرت وزارة الدفاع الأمريكية نظام المشتريات، بالانتقال من تفضيل المواصفات العسكرية إلى تفضيل المواصفات المدنية. وعندما سمحت القوات الجوية الأمريكية بشراء مكونات مدنية، أصبحت تكلفة ذخيرة الهجوم المباشر المشتركة «جدام» (JDAM) Joint Direct Attack Munition حوالي نصف التكلفة السابقة. وكان برنامج طائرات النقل العسكري طراز C-17 على وشك الإلغاء في عام 1993، ولكنه أصبح في ظل النظام الجديد يوفر الاحتياجات المطلوبة قبل الموعد، ويحقق وفورات في حدود 5 مليارات دولار نتيجة لاستخدام المكونات المدنية.
وأذن الكونجرس الأمريكي في عام 1995 بتنفيذ خمسة برامج تجريبية، ومنح مديريها سلطة كاملة في استخدام المكونات والممارسات المدنية، ولم تكن لتلك البرامج الخمسة أهميتها لما تستطيع أن تحققه من وفورات، فحسب، بل أيضا لأنها تستطيع أن تكون الرائدة أمام كل عمليات الشراء لوزارة الدفاع، حيث أن التوسع في استعمال المكونات المدنية لا يؤدي فقط إلى خفض التكلفة، بل يفضي أيضاً إلى إيجاد منتجات أفضل. ومن البرامج الخمسة المختارة: برنامج القنابل JDAM، وجهاز التدريب التكتيكي على الأسلحة المشتركة، ونظام التدريب الأولي على الطائرات. وأثبتت هذه البرامج أنه يمكن، من خلال استخدام المنتجات المدنية تحسين جداول التطوير والتسليم، بتكلفة أقل.
وعلى مدى سنوات، كانت القوات المسلحة في العالم تستخدم أجهزة كمبيوتر تخضع لظروف اختبارات قاسية، بحيث تكون قادرة على العمل في درجات حرارة أقل من الصفر، وأعلى من 170 درجة مئوية، ويمكنها أن تتحمل التصادم بأوزان تصل الى 30 رطلاً. وهذه الأجهزة يكون لها هيكل خارجي قوي للحفاظ على مكوناتها الداخلية التي تثبت بشكل يؤمن عدم تحركها عند تعرضها للصدمات. وتطلبت هذه القيود زيادة الميزانيات. ولكن منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي، بدأ التفكير في تخفيف هذه القيود، خاصة بعد أن أثبتت الحروب في الخليج وأفغانستان كفاءة أداء أجهزة الكمبيوتر التي صممت للاستخدامات المدنية، ودفع ذلك المسؤولين العسكريين للجوء إلى الشركات المدنية.
اتفاقيات مراقبة الاستخدام المزدوج للتقنية
تشكل التقنيات ذات الاستخدام المزدوج عقبة كبيرة أمام الحد من انتشار الأسلحة، فأي استراتيجية قائمة على منع الوصول إلى منتجات مزدوجة الاستخدام غير ممكنة. والتقنية المزدوجة ليست تهديداً بحد ذاتها، ومنع الوصول إليها لا يتم إلا عندما يظهر اتجاه إلى سوء استخدامها، أو عندما يكون خطر احتمال إساءة استخدامها شديداً. ويوجد حالياً أربع اتفاقيات للمراقبة الدولية للاستخدام المزدوج للتقنية، من أجل تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي، ومنع وصول هذه التقنيات إلى الجماعات المتطرفة، وهذه الاتفاقيات هي:
• اتفاقية واسينار (WA) Wassenaar Arrangement )نسبة الى مدينة «واسينار» الهولندية التي شهدت توقيع الاتفاق) بشأن ضوابط التصدير على الأسلحة التقليدية والتقنيات والبضائع ذات الاستخدام المزدوج: وهي نظام لمراقبة التصدير متعدد الأطراف (MECR)Multilaterlal Export Control Regime من خلال هيئة دولية، تكونت عام 1996، تتبعها 42 دولة لمراقبة عمليات التصدير الوطنية لديها. وهذه الاتفاقية ليست معاهدة ملزمة قانونياً للأعضاء. وكل 6 أشهر يتبادل أعضاء الاتفاقية المعلومات الخاصة بتسليم الأسلحة التقليدية للدول غير الأعضاء. وتتضمن هذه الأسلحة: الدبابات، مركبات القتال المدرعة، المدافع كبيرة العيار، الطائرات العسكرية ثابتة الجناح، العموديات العسكرية، السفن الحربية، أنظمة المقذوفات، والأسلحة الخفيفة والصغيرة.
• مجموعة موردي المواد النووية The Nuclear Suppliers Group (NSG) لمراقبة التقنيات النووية: وتضم عدداً من الدول الموردة للمواد النووية، وتهدف إلى منع الانتشار النووي، وتكونت عام 1975 من سبع دول، وتضم الآن 48 دولة، وتتوافق أهدافها مع كل المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بهذا الشأن.
• مجموعة أستراليا The Australia Group (AG) لمراقبة التقنيات الكيميائية والبيولوجية التي يُمكن استخدامها في الأسلحة: وهي مجموعة غير رسمية، تكونت عام 1985، من 15 دولة، ولكنها الآن تضم 43 دولة، وتهدف إلى تقليل مخاطر انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وتعقد اجتماعاً سنوياً في باريس.
• نظام مراقبة تكنولوجيا المقذوفات Missile Technology Control Regime (MTCR): وضع هذا النظام عام 1987 بواسطة الدول الصناعية السبع G-7، وتشارك فيه الآن 35 دولة، لتحديد معايير لعدم انتشار المنصات القادرة على حمل أسلحة دمار شامل )باستثناء الطائرات التي يقودها طيارون(، مع التركيز على الصواريخ والطائرات المسيرة التي تحمل أكثر من 500 كيلوجرام (1100 رطل) ويزيد مداها على 300 كم (190 ميل).
وإضافة الى هذه الاتفاقيات، تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على الدول التي تصدر مواد ذات استخدام مزدوج لأغراض مدنية وعسكرية، أو تقنيات حساسة، يمكن استخدامها في صنع أسلحة محظورة، كما تفرض حظراً على الدول المستهدفة، لمنعها من الحصول على مواد وتقنيات يمكن استخدامها في صنع مثل هذه الأسلحة. وتتهم الولايات المتحدة روسيا والصين ببيع تقنيات حساسة يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية إلى دول مثل إيران وكوريا الشمالية، التي ترى فيها واشنطن تهديدا على صعيد انتشار الأسلحة غير التقليدية.
وربما تجدر الإشارة هنا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 لعام 2004. ففي الثامن والعشرين من أبريل 2004، قرر المجلس بالاجماع أن تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو امتلاك هذه الأسلحة والوسائل، أو صنعها، أو نقلها، أو استعمالها.
الخلاصة
على مر التاريخ، تنفق الدول بسخاء في سبيل تطوير التقنيات التي تتطلبها الاستخدامات العسكرية، سواء لما يمثله ذلك من أهمية لأمنها القومي، أو لتحقيق عائد كبير من تسويق هذه التقنيات في سوق السلاح. ولذلك، فإن تطوير هذه التقنيات لم يتأثر كثيراً بمعوقات السوق الطبيعية، أو بالظروف الاقتصادية، كما هو الحال بالنسبة للتقنيات التي يتم تطويرها خصيصاً للاستخدامات المدنية، والتي كان الإنفاق عليها يتم بمعدلات أقل. وكان من الطبيعي أن تكون هناك محاولات للاستفادة من التقنيات العسكرية في المجالات المدنية، كما حدث في العديد من التطبيقات، وعلى رأسها الطيران، والراديو، والرادار، والكمبيوتر، والفضاء، حيث أدرك الطرفان، العسكري والمدني، أنه أينما تتفق المواصفات العسكرية مع المواصفات المدنية، عادة ما يتسارع التقدم التقني. بالإضافة إلى أن ذلك يمثل أكثر الطرق فعالية من ناحية التكلفة.
» لواء د. علي محمد علي رجب (باحث عسكري وخبير استراتيجي)